تفعيل "آلية الزناد".. هل باتت الطلقة القاتلة قريبة؟

تشير الشواهد والمؤشرات الدبلوماسية إلى أن تفعيل "آلية الزناد" لم يعد احتمالاً بعيدًا، بل أصبح واقعًا وشيكًا.
"إيران إنترناشيونال"

تشير الشواهد والمؤشرات الدبلوماسية إلى أن تفعيل "آلية الزناد" لم يعد احتمالاً بعيدًا، بل أصبح واقعًا وشيكًا.
فبحلول نهاية صيف هذا العام، أي قبل نهاية سبتمبر (أيلول) 2025، قد يُعاد فرض العقوبات المعلّقة من قِبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران تلقائياً- دون الحاجة إلى تصويت ودون إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو)-بناءً على الآلية المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي السابق (2015).
وهذه العقوبات تشمل حظر بيع النفط والتعاملات المصرفية، بالإضافة إلى القيود على التسليح، والأنشطة المالية، والاستثمارات.
وفي حال حدوث ذلك، سيكون بمثابة ضربة قاصمة لبنية النظام الحاكم في إيران، غير أن العبء الأكبر سيقع مباشرة على كاهل الشعب الإيراني: من موائد الطعام إلى الصيدليات، من ثلاجات المنازل إلى آفاق التوظيف والأمل.
لماذا توشك أوروبا على اتخاذ القرار الآن؟
في عام 2020، حاولت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فترة ولايته الأولى، تفعيل آلية الزناد، رغم انسحابها الرسمي من الاتفاق النووي الإيراني، عام 2018، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف بتلك الخطوة، على اعتبار أن الولايات المتحدة لم تكن عضوًا في الاتفاق آنذاك.
أما اليوم، فقد أعلنت الدول الأوروبية الثلاث المتبقية في الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) رسميًا أن طهران قد انتهكت التزاماتها النووية، إذ:
* رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 60 في المائة.
* قلّصت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
* وسّعت تعاونها العسكري مع روسيا وكوريا الشمالية.
* ووضعت تكنولوجيا صاروخية بيد الجماعات الوكيلة في المنطقة.
لماذا لم تُفعّل آلية الزناد بعد؟
لأن تفعيل الآلية يُعد بمثابة إعلان وفاة رسمي للاتفاق النووي لعام 2015. وقد هددت إيران بأنه في حال اتخاذ هذه الخطوة، فإنها قد تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتبدأ علنًا مسار إنتاج القنبلة النووية.
ورغم ذلك، فإن لدى أوروبا حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025 فقط لتفعيل آلية الزناد. أي أن القرار النهائي يجب اتخاذه خلال الشهر أو الشهرين المقبلين.
تأثير مباشر على حياة الإيرانيين
سيكون لتفعيل آلية الزناد أثر مباشر وملموس وكارثي على حياة المواطنين الإيرانيين؛ حيث إن:
* عودة العقوبات النفطية تعني انخفاضًا حادًا في إيرادات الدولة.
* فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني يعني قطع الاتصال بالنظام المالي العالمي، ومِن ثمّ ارتفاع كبير في سعر صرف العملة.
* توقف الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعني يعني ركودًا وتضخمًا وبطالة متفاقمة.
* قائمة العقوبات الطويلة تشمل قطاعات مرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية: من المواد الغذائية إلى البنى التحتية الحيوية.
وكل هذا يقع على عاتق مجتمع استُنزفت قدرته على التحمل بفعل الفساد وسوء الإدارة والعقوبات الممتدة لسنوات.

بدأ المحللون السياسيون في طهران يدقون ناقوس الخطر بشأن التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأممية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تقول الدول الأوروبية إنها قد تعيد فرضها على إيران بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل.
كانت هذه العقوبات قد رُفعت في إطار الاتفاق النووي عام 2015، وهو الاتفاق الذي انهار عمليًا في عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) ستفعّل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" المضمّنة في الاتفاق، ما لم يتحقق تقدم ملموس بشأن اتفاق نووي جديد.
وفي افتتاحية نشرتها صحيفة "جهان صنعت"، اليومية الاقتصادية الرائدة في إيران، نقلت فيها عن خبير العلاقات الدولية علي بيكدلي، قوله: "إذا تم تفعيل آلية العودة التلقائية وأُعيد فرض القرارات المعلقة، فسيكون جميع أعضاء الأمم المتحدة- بما في ذلك الصين وروسيا- ملزمين بالتعاون في تنفيذ العقوبات على إيران، ولن يكون بمقدورهم التنصل من الالتزام بها".
تصعيد وغموض
هذا النوع من التحذيرات يُقابل بالاستخفاف من قبل الأصوات الأكثر تشددًا في إيران، والتي ترد بتصعيد الخطاب العدائي بدلاً من ذلك.
فقد حذرت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، يوم الثلاثاء، من أن إيران قد ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 60 بالمائة إلى 90 بالمائة وربما تستخدم مخزونها من اليورانيوم المخصب لأغراض "عسكرية غير محظورة" حسب تعبيرها.
وقد جرى تداول هذا التقرير على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيرانية، إلا أنه حُذف بهدوء خلال ساعات.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، قد صرح قبل يوم من ذلك بأن رد طهران على العودة التلقائية للعقوبات سيكون "متناسبًا"، من دون تحديد التفاصيل، ما ترك المتابعين أمام احتمالات مفتوحة.
من جهته، اتهم النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه، الدبلوماسيين الإيرانيين بـ"انعدام الكفاءة"، وانتقد بشدة المتشددين بسبب ما وصفه بـ"السرديات الزائفة".
وقال في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية المعتدلة: "على الرئيس بزشكيان أن ينهي سلبيته في السياسة الخارجية وينقذ المصالح الوطنية من قبضة المتشددين"، موجّهًا في الوقت ذاته انتقادات قاسية للاتفاق النووي لعام 2015 وللذين وقعوه.
ونقلت صحيفة "شرق" الإصلاحية البارزة عن المحلل محمد إيراني تحذيره من "زلزال سياسي" وإغلاق فعلي لباب الدبلوماسية.
وحذر إيراني من أن تفعيل العودة التلقائية للعقوبات من قبل أوروبا، التي تسعى لإعادة تعريف دورها بعد فترة من المراقبة من بعيد، من شأنه أن يُغلق إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.
ومع تصاعد التعليقات، بدأ بعض الكتّاب يُلفتون الانتباه إلى الهشاشة الكامنة في الافتراضات التي يقوم عليها موقف إيران الحالي، وإلى مخاطر الحسابات الخاطئة.
وكتب المحلل مهدي بازوكي في "آرمان ملي": "تُعد العودة التلقائية للعقوبات واحدة من أخطر التحديات التي تواجه إيران سياسيًا واقتصاديًا"، مضيفًا أن هذه المياه المضطربة قد يمكن اجتيازها إذا لجأت طهران إلى "دبلوماسية واقعية واستباقية".
لكن بازوكي حذر من أن "لو" تزداد ثقلاً، نظرًا لتزايد غياب الواقعية في سياسة إيران الخارجية.
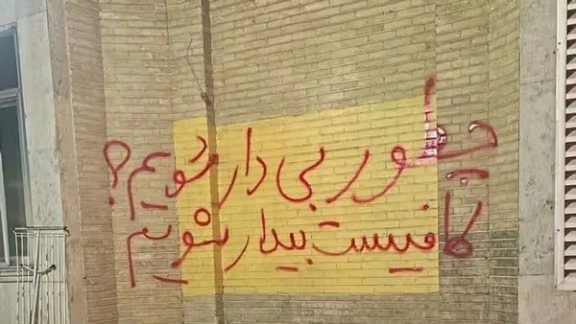
بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل ووقف إطلاق النار الذي أعقبها، يواجه مئات المواطنين في إيران خطر صدور أحكام قاسية بحقهم، بما في ذلك الإعدام، نتيجة القضايا التي افتعلتها الأجهزة الأمنية والقضائية.
يقدم هذا التقرير دليلًا عمليًا لأولئك الراغبين في مقاومة القمع والعمل على إنقاذ حياة المعتقلين.
في طريق الدفاع عن حياة المعتقلين، يجب ألا يكون هناك تمييز على أساس الانتماء السياسي أو المعتقد الديني أو نمط الحياة. حتى إن كان المعتقلون يحملون آراءً مختلفة أو معارضة، فإن الدفاع عن الحق في الحياة والحقوق الإنسانية هو مبدأ شامل غير قابل للتفاوض.
وشهدت إيران خلال الشهر الماضي تصعيدًا أمنيًا جديدًا تمثل في حملات اعتقال جماعية وتشديد كبير على الحريات العامة.
طالت هذه الاعتقالات ليس فقط الناشطين السياسيين والمدنيين، لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، وأفرادًا من الأقليات الدينية مثل اليهود، والبهائيين، والمسيحيين، وحتى أجانب يقيمون في إيران، مما زاد من القلق بشأن تصاعد القمع.
وإلى جانب التقارير المتعددة حول انقطاع التواصل تمامًا مع عائلات المعتقلين وبث الاعترافات القسرية لبعضهم، تتزايد المخاوف من المحاكمات المستعجلة وغير العادلة، وصدور أحكام بالإعدام أو السجن المطوّل.
تشير الإحصائيات الصادرة عن وسائل إعلام حقوقية إلى أن السلطات الإيرانية اعتقلت، منذ بداية الحرب مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، ما لا يقل عن 2000 شخص في مختلف المدن الإيرانية.
وأعلنت السلطة القضائية صراحةً أن ملفات هؤلاء المعتقلين- الذين يواجه بعضهم اتهامات مثل "التجسس"- سيتم البت فيها بـ"أولوية قصوى".
وفي أحدث تصريح له، هدّد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، بأن المعتقلين الذين اتُّهِم بعضهم بـ"التجسس"، سينالون "عقابهم الكامل"، مشيرًا إلى تنفيذ أحكام إعدام بحق آخرين.
وقد حذّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من تصاعد القمع وإمكانية تكرار مجازر مثل "مجزرة صيف 1988".
أهمية التبليغ السريع
لطالما أنكرت الأجهزة الأمنية الإيرانية، على مدى عقود، وجود المعتقلين أو امتنعت عن الكشف عن أماكن احتجازهم أو حالتهم الصحية.
الإعلان العلني عن الاعتقال يُحمّل الجهات الأمنية مسؤولية سلامة المعتقل ويجبرها على الرد.
في غياب التبليغ، قد يبقى المعتقل "مختفيًا قسريًا" لأسابيع أو شهور، دون تسجيل رسمي، أو زيارة، أو تمثيل قانوني، ومعرضًا للتعذيب في زنزانات انفرادية تُعرف باسم "أم الإعدام".
في سجون إيران، تُسمى الزنزانات الانفرادية "أم الإعدام"، لأن المعتقلين السياسيين يوضعون فيها في بداية فترة احتجازهم، حيث يتعرضون للتعذيب، ويُحرمون من حق الاتصال بالعائلة أو المحامي. وتُنتزع منهم اعترافات قسرية، تُستخدم لاحقًا كأساس لإصدار أحكام بالإعدام.
خلاصة التجربة: نسبة كبيرة من المعتقلين خلال الأسابيع الأولى يتعرضون للتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات، وإذا لم تُبادر عائلاتهم بالإبلاغ السريع، يتفاقم الخطر.
لهذا فإن التبليغ السريع والواسع عن حالات الاعتقال هو الخطوة الأساسية الأولى في مواجهة القمع.
وكلما سارعت العائلة أو الأصدقاء بإعلان خبر الاعتقال، تقلّصت قدرة النظام على الاستفراد بالمعتقل، وزادت فرص نجاته.
أما الصمت، فقد أدى في كثير من الحالات إلى الإخفاء القسري، والاعتراف القسري، ومن ثم صدور أحكام بالإعدام أو السجن الطويل.
كثير من المعتقلين السياسيين الذين أُعدِموا في العقود الأربعة الماضية، قيل لهم أو لعائلاتهم عند الاعتقال إن "الأمر مجرد تحقيق بسيط" وسيعودون قريبًا. لكنهم لم يعودوا قط، بل أُعدموا بعد أيام أو شهور أو سنوات.
يُرسل الإعلان العلني عن الاعتقال رسالة إلى أجهزة الأمن مفادها أن الملف بات تحت الرقابة العامة، وأن أي تجاوز ستكون له تبعات دولية.
ما ينبغي فعله فور الاعتقال:
•الإبلاغ العاجل عبر وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمات حقوق الإنسان
•نشر اسم المعتقل الكامل، صورته، عمره، مكان ميلاده، مهنته، مجال دراسته، مكان وتاريخ
اعتقاله، الجهة التي اعتقلته، ومكان احتجازه المتوقع
•إرسال تحديثات مستمرة عن حالته القانونية
•إنتاج محتوى مؤثر عن حياته وشخصيته
•استخدام قنوات إعلامية آمنة
الإعلام من أقوى أدوات مواجهة القمع. إذا حظي اعتقال شخص ما بتغطية واسعة، يصعب على القضاء والأمن الاستمرار في الإجراءات التعسفية.
تكرار ذكر أسماء المعتقلين في الإعلام المحلي والدولي يمكن أن يغيّر مسار القضايا، ويمنع بقاءهم في العزل الانفرادي، وبالتالي يقلّل خطر صدور أحكام الإعدام.
وقد أنقذت التغطية الإعلامية حياة كثيرين سابقًا.
لكن يجب الحذر من نشر مزاعم بلا دليل، أو أقوال قد تستغلها السلطات لتبرير القمع، كاتهام المعتقل بنشاط أمني دون سند.
وسائل الدعم الإعلامي:
•إرسال المعلومات للصحفيين المتخصصين
•إجراء مقابلات مع عائلات المعتقلين
•إنشاء هاشتاغات خاصة بكل معتقل
•تنظيم حملات توقيع تطالب بالإفراج عنه
•الاستفادة من الإعلام المحلي والدولي لنشر مستجدات قضيته
دعم العائلات نفسيًا وماديًا
تعاني العائلات من ضغوط مالية ونفسية شديدة، وتفقد أحيانًا معيلها الوحيد.
كما تواجه تكاليف المحاماة، العلاج، وزيارات السجن.
أشكال الدعم الممكنة:
•إنشاء صناديق مالية للمساعدة
•تقديم استشارات قانونية ونفسية مجانية
•دعم تعليم وصحة أطفال المعتقلين
•زيارة النشطاء لعائلات المعتقلين
•توفير أدوات اتصال آمنة وVPN
•إرسال أجهزة آمنة (هاتف – كمبيوتر) من الخارج
•تقديم دورات في الأمان الرقمي
•الانضمام لشبكات العائلات المتضررة للاستفادة من خبراتهم
كثير من المعتقلين يُفرج عنهم بشروط، ويظل الضغط عليهم قائمًا.
يجب مواصلة الدعم بعد الإفراج:
•تغطية إعلامية بعد الإفراج
•دعم فرص العمل والتعليم
•المساعدة في طلب اللجوء حال استمرار التهديد
•الدعم النفسي والاجتماعي
الرأي العام قادر على إيقاف القمع أو إبطائه. كلما زاد الحديث عن معتقل، ارتفعت كلفة إبقائه رهن الاحتجاز.
أدوات الضغط:
•حملات على منصة "إكس" في تواريخ مفصلية
•دعم حملات مثل "ثلاثاء لا للإعدام"
•احتجاجات في الخارج
•إرسال خطابات للمؤسسات الدولية
•استخدام مشاهير الفن والرياضة والسياسة في حملات الدعم
النقابات والمؤسسات الأكاديمية والرياضية يمكنها لفت الأنظار دوليًا للقمع في إيران.
إجراءات مقترحة:
•بيانات رسمية من الجمعيات المهنية
•متابعة وضع الطلاب المعتقلين
•مقاطعة البطولات الرياضية
•التواصل مع الهيئات الدولية المرتبطة بالمعتقل
(نقابات الصحفيين، اتحادات الرياضيين، جمعيات الأطباء...)
الأنشطة الفنية يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في إيصال صوت المعتقلين إلى العالم.
أمثلة:
•أفلام وثائقية عن القضايا
•معارض صور ولوحات
•عروض مسرحية وحفلات موسيقية احتجاجية
•ملصقات ومنشورات رقمية
•بودكاستات وقصص صوتية
•مشاركة في مهرجانات فنية وحقوقية
•ترجمة الأعمال إلى لغات متعددة
ماذا يمكن أن يفعله الإيرانيون في الخارج؟
بسبب حرية الإعلام والتواصل، الإيرانيون في الخارج يملكون أدوات قوية:
ما يمكن فعله:
•تنظيم مظاهرات وفعاليات رمزية
•لقاء النواب والبلديات والحكومات
•عرض صور المعتقلين في الأماكن العامة
•إنتاج فيديوهات وبودكاستات
•التواصل مع المؤثرين لنشر القضية
•تقديم الدعم الفني (ترجمة، أمن رقمي...)
•توعية المجتمعات المضيفة
الدعم الإلكتروني والأمن السيبراني
•إطلاق حملات منسقة عبر الإنترنت
•تأمين اتصالات العائلات والنشطاء
•التبليغ عن حسابات القمع إلى المنصات العالمية
•رصد ومواجهة الحملات التخريبية التابعة للنظام
التواصل مع منظمات حقوق الإنسان يعرقل القمع، ويمكنه إنقاذ الأرواح.
كيف؟
* إرسال تقارير موثقة إلى هيئات مثل:
* لجنة تقصي الحقائق بالأمم المتحدة
* العفو الدولية
* هيومن رايتس ووتش
* هرانا
* منظمة حقوق الإنسان في إيران
* مطالبة هذه الهيئات ببيانات عاجلة
* الضغط لتحريك برلمانات وحكومات
* مطالبة الدول بإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية
* التواصل مع سفارات الدول المعنية (جنسية مزدوجة – إقامة سابقة...)
الملاحقة القضائية الدولية
المسار القانوني الدولي يمكن أن يكون رادعًا.
إجراءات:
•تقديم ملفات إلى محكمة لاهاي
•رفع قضايا في الدول الديمقراطية ذات "الاختصاص العالمي"
•توثيق أدوار المتورطين وطلب مذكرات توقيف
•التعاون مع محامين دوليين
•دعم لجان الحقيقة والتوثيق التابعة للأمم المتحدة
رغم أن القمع قد لا يتوقف فورًا، فإن التوثيق الدقيق لكل انتهاك يبني أساس العدالة المستقبلية.
أدوات:
•تسجيل شهادات العائلات بالصوت أو الصورة
•توثيق طبي للإصابات
•التعاون مع منظمات التوثيق
•الضغط لتحريك العقوبات الحقوقية على الجناة
•حفظ الأمان الرقمي أثناء جمع الأدلة
العمل الجماعي يصنع الفرق
مع تهديد النظام الإيراني بـ"الحسم السريع" مع المعتقلين، فإن كل لحظة تأخير أو صمت قد تعني فقدان حياة.
التبليغ، الضغط الإعلامي، والتحرك المنظم هي أدوات متاحة للجميع.
كل فرد قادر على إحداث فرق عبر خطوات صغيرة ومستمرة، في مواجهة آلة القمع.
الصمت هو تواطؤ. التبليغ والعمل الجماعي هو السبيل لإنقاذ الأرواح ووقف دائرة الظلم.

يرى خبراء تحدّثوا إلى" إيران إنترناشيونال" أن الانشقاق من داخل القوات المسلحة الإيرانية قد يُشكّل تهديدًا جديًا للنظام الإيراني، لكن بشرط توفر الحماية، ومسار آمن للخروج، وهيكل يمكن الوثوق به.
ويقول مايكل بریجنت، الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية: "كانت هناك لحظة، خلال تلك الاثني عشر يومًا من الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، بدا فيها أن النظام يهرب. الناس كانوا يراقبون عن كثب. كان هناك زخمٌ واضح. لكن في غياب ملاذ آمن أو دعم حقيقي، تُرِك من كانوا يفكرون في الانشقاق بلا وجهة".
وقد عاد الحديث عن الانشقاقات المحتملة إلى الواجهة بعد أن أعلن رضا بهلوي، ولي العهد الإيراني المنفي، أن أكثر من 20 ألف عنصر من القوات المسلحة الإيرانية تواصلوا مع مكتبه عبر منصة إلكترونية للتسجيل، وأعربوا عن رغبتهم في الانشقاق.
ورغم عدم إمكانية التحقق المستقل من هذا الرقم، إلا أن ذلك زاد من التساؤلات حول ولاء الأجهزة الأمنية للنظام، والظروف التي قد تدفع عناصرها إلى الانشقاق.
يؤكد باتریك کلاوسن، الباحث في معهد واشنطن، أن أحد أكبر العوائق أمام الانشقاق هو التخوف من الانتقام: "المشكلة الأهم عادةً هي: كيف يمكن للمنشقين إخراج عائلاتهم وأصدقائهم؟. لدى النظام الإيراني سجل طويل في أخذ رهائن لا علاقة لهم بالتهم... يمكننا أن نفترض أن النظام سيسعى للانتقام من عائلات المنشقين وأصدقائهم".
ويضيف علي رضا نادر، كبير المحللين في الشأن الإيراني، أن الانشقاقات لن تكتسب زخمًا حقيقيًا ما لم يقتنع المنتمون إلى الأجهزة الأمنية بأن لديهم مستقبلًا مضمونًا خارج النظام.
يقول بریجنت إن ما قد يُحدث تحولًا هو إنشاء مناطق آمنة، سواء فعلية أو تنظيمية، تُوفّر للمنشقين حماية ومساحة لإعادة التنظيم.
واستشهد بتجربته في العراق خلال حملة مكافحة التمرد الأميركية، حين عمل مع شيوخ قبائل ومنشقين، قائلاً: "تم بناء الثقة من خلال توفير المعدات، والدعم اللاسلكي، والحماية المسلحة".
ويرى أن هذا النموذج يمكن تكييفه لدعم الإيرانيين المستعدين للانفصال عن النظام، مشددًا على أن الثقة تُبنى بالأفعال، لا بالكلام، وعلى وجود أشخاص "مستعدين للمخاطرة بحياتهم".
ويضيف: "رأينا ذلك مع الإسرائيليين... هناك شبكة سرية داخل إيران"، في إشارة إلى خلايا مسلحة نفذت اغتيالات وعمليات تخريب نووي بالتنسيق مع إسرائيل. الثقة تكمن في هؤلاء الذين كانوا مستعدين للقتال من أجل هذا الهدف، مستعدين للمجازفة".
تعاون من الداخل مع إسرائيل
وتُظهر الاغتيالات الدقيقة التي نفذتها إسرائيل في طهران، كاغتيال القيادي في الحرس الثوري علي شادماني، وإسماعيل هنية (زعيم حماس)، أن هناك تعاونًا داخل البلاد مع إسرائيل. فمثل هذه العمليات مستحيلة دون دعم بشري على الأرض.
وقد قُتل هنية يوم 31 يوليو (تموز) 2024 داخل دار ضيافة عسكرية في طهران، بعد وقت قصير من حضوره مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان. وقد أظهرت العملية، كما سابقاتها، تفوق الاستخبارات الإسرائيلية ووجود مخبرين محليين في أوساط أمنية وسياسية حساسة داخل النظام الإيراني.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعترفوا صراحة بهذه العمليات، فإن سفير إسرائيل في واشنطن قدّم تلميحًا نادرًا ومقصودًا في ندوة لـ"إيران إنترناشيونال" في العاصمة الأميركية.
ورداً على سؤال حول كيفية تمكن إسرائيل من استهداف أفراد في غرف نومهم في أماكن نائية بطهران، أجاب: "أعني... ما الذي تتوقعه؟ أعتقد أن الجواب يكمن في السؤال. وأظن أنه يعود إلى كيفية التغلب على الخوف. الكثير من الإيرانيين تغلبوا على خوفهم، وقد تعاونوا، وسيتابعون التعاون مع قوى الخير"، بحسب تعبيره.
ورغم أنه استخدم لغة غير مباشرة، فإن حديثه يُلمح بوضوح إلى تعاون بين الاستخبارات الإسرائيلية ومناصرين من الداخل الإيراني.
يشير كلاوسن إلى أن الغموض القانوني والدبلوماسي يمثل أيضًا عائقًا. الدول المحتملة لمنح اللجوء يجب أن تُظهر وضوحًا ليس فقط بشأن حماية المنشقين، بل أيضًا بشأن استقبال وحماية عائلاتهم، وهو أمر لا يزال غامضًا من الناحيتين القانونية والعملية.
كما أشار إلى أن وكالات الاستخبارات تميل غالبًا إلى الاحتفاظ بالمصادر داخل النظام بدلًا من تسهيل خروجهم، لأن العملاء المزدوجين أكثر فائدة. وفي كثير من الحالات، يُطلب من المصدر أن يبقى في منصبه لتقديم معلومات من الداخل.
ويؤكد نادر أن الشخصيات السياسية في المنفى يجب أن تُقيّم بالأفعال لا بالنوايا. فإذا كانوا يريدون نيل ثقة الإيرانيين، فعليهم إظهار نتائج ملموسة، خصوصًا في ظل الاضطرابات الإقليمية والداخلية.
ويُجمع الخبراء على أن التمرد الداخلي أو الانشقاق الواسع في صفوف النظام الإيراني غير مرجّح ما لم يحصل المنشقون المحتملون على دعم خارجي ومسار واضح للخروج.
ويختم مايكل بریجنت قائلاً: "هذا لن يحدث دون وجود ملاذ آمن".

في أيامٍ اجتاحت فيها صور طرد المهاجرين الأفغان من إيران وسائل الإعلام، نشهد أطفالًا يُجبرون على عبور الحدود جياعًا وعطاشى في حر الصيف، ونساءً يُتركن بلا مأوى، وعائلاتٍ لم تتح لها حتى فرصة استرداد عربون منازلها.
يثار التساؤل: ما الذي حلّ بنا؟ وكيف تحوّل مجتمعٌ كان ملاذًا للمهاجرين واللاجئين، إلى مجتمعٍ يطردهم بقسوة ووحشية؟
الجواب يكمن في تقاطع ثلاثة عوامل: الأزمة البنيوية في الدولة، اليأس الاجتماعي، وتكريس مشروعٍ واعٍ لـ"صناعة الآخر"، يُنفذ بدعم من السلطة السياسية والإعلام الرسمي.
الهروب من المساءلة واللجوء إلى القومية المتطرفة
منذ سنوات، يعجز النظام الإيراني عن تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه، من الخبز والعمل إلى السكن والماء النظيف. سجلها في هذا المجال ليس فقط فارغًا، بل سلبيًّا للغاية. يُضاف إلى ذلك الفشل في مغامراته الإقليمية، لا سيما في "الحرب مع إسرائيل"، وانهيار سياساته التوسعية.
في ظلّ هذا الواقع، تبدو أفضل طريقة لترويض الغضب الشعبي هي توجيه الرأي العام نحو "عدوّ قريب" يمكن الوصول إليه. المهاجرون الأفغان، بصفتهم فئةً صامتة بلا دعم ولا تنظيم رسمي، هم هدفٌ سهل. فهم لا يملكون سلطة إعلامية ولا أدوات ضغط سياسي، والأهم من ذلك: يُنظر إليهم كـ"غرباء".
صناعة الكراهية
إن حملة الكراهية ضد المهاجرين منظمة بالكامل وتستند إلى الأكاذيب والتضليل. فرغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود قرابة مليونين إلى ثلاثة ملايين مهاجر أفغاني في إيران، تروج وسائل إعلام قريبة من الأجهزة الأمنية وشخصيات سياسية لأرقام خيالية تتراوح بين خمسة إلى عشرة ملايين، دون أي دليل.
ويُتّهم المهاجرون بالاستيلاء على الوظائف، والتسبب في أزمة الإسكان، وزيادة الجريمة، بل وحتى بتهديد الأمن القومي. لكن لا توجد أي دراسات مستقلة تؤكد هذه الادعاءات. بل العكس، فغالبيتهم يعملون في أصعب الوظائف وأقلها أجرًا، ويتحملون العبء الأكبر من الاقتصاد غير الرسمي في إيران.
لكن لماذا ينساق جزء من المجتمع مع هذه الحملة؟ الجواب، رغم مرارته، واقعي: المجتمع الإيراني غاضب من الفقر، والتمييز، والقمع، والمستقبل الغامض. وعندما لا يجد هذا الغضب متنفسًا صحيحًا، فإنه يتجه نحو "البحث عن ضحية".
وكما أظهرت تجارب الشعوب الأخرى، فإن الجماهير اليائسة مستعدة دومًا لتفريغ غضبها في وجه "الآخر" المختلف عنها.
يكتب الفيلسوف البريطاني جوناثان ساكس عن جذور الكراهية قائلًا: نحن مخلوقات قبلية.
نتعاطف مع من هم من "جماعتنا"، لكننا نخاف الغرباء. وإن لم يُكبح هذا الخوف، فإنه يحوّلنا إلى وحوش. فالأخلاق، برأيه، لا تُنقذ إلا إذا حوّلت الـ"أنا" إلى "نحن" من دون إقصاء "هم" عن دائرة الإنسانية. لكن، بمجرد أن نبني "نحن"، يولد "هم"، وهنا تبدأ كراهية الآخر.
في علم النفس الاجتماعي، تُعدّ حاجة الإنسان إلى إيجاد مذنب وسيلة دفاعية للهروب من مواجهة الواقع المرير. فقبول حقيقة أن أزمة البلاد ناتجة عن عقود من الفساد وسوء الإدارة والعزلة الدولية، أصعب بكثير من لوم مهاجر بلا صوت ولا حماية.
وهذه الآلية إذا تُركت بلا مواجهة، فلن تتوقف عند المهاجرين فقط. فدور النساء، والأقليات، والشباب المعارض، وأي صوت "غير منتمٍ"، سيأتي لاحقًا. وهذه بداية انهيار التضامن الوطني والأخلاق العامة.
فإذا لم يُوجّه الغضب الشعبي في مسار سليم، وإذا عجز المجتمع عن توجيه نقده نحو السلطة الحقيقية، فإن عادة البحث عن ضحية ستصبح إدمانًا خطيرًا؛ عدوٌ دائم في الجوار، ومسؤولية لا تقع أبدًا على الجذور الحقيقية للأزمة.
الدولة: المسؤول الأول
تتحمل الدولة المسؤولية المباشرة، لا فقط في إشعال الكراهية، بل أيضًا في تقاعسها عن أداء أبسط واجباتها.
فلماذا بعد أكثر من 40 عامًا، لم تُؤسس إيران أي هيكل منظم لاستيعاب وتدريب وتوجيه المهاجرين؟ لماذا لا توجد مخيمات رسمية دائمة للاجئين على الحدود الشرقية؟ ولماذا لا يزال وصول المهاجرين إلى التعليم، والرعاية الصحية، والعدالة، محدودًا وتحت رحمة الأهواء؟
الجواب بسيط: ليس الإهمال فقط، بل وجود إرادة سياسية لإبقاء المهاجرين في حالة عدم استقرار، واستغلالهم سياسيًّا. هذا الوضع غير القانوني جعل منهم قوة عمل رخيصة ومطيعة وصامتة، وأداة مناسبة لتحميلهم مسؤولية الأزمات الداخلية.
كراهية الآخر بداية الانهيار الأخلاقي
ما نشهده اليوم تجاه المهاجرين الأفغان ليس فقط كارثة إنسانية، بل مؤشر مقلق على انهيار أخلاقي في مجتمعٍ كان يومًا ما يفتخر بتعدديته الثقافية والدينية.
كراهية الآخر، إذا لم يتم التصدي لها، لا تعرف حدودًا. وإذا أصبحت الكراهية مؤسسة، فإنها لن تقتصر على المهاجرين، بل سرعان ما تستهدف الأقليات القومية والدينية والفكرية، كما فعلت من قبل.
فلا ننسَ أن هذه المنظومة الإقصائية طُبّقت من قبل ضد الأكراد، والبلوش، والبهائيين، وغيرهم من الأقليات، وكذلك ضد المفكرين المستقلين، والناشطين المدنيين، والمعارضين السياسيين.
كراهية الآخر ليست فقط وسيلة لقمع "الآخر"، بل هي أيضًا مقدمة لانهيار الـ"نحن". فالمجتمع الذي يعتاد اعتبار فئة من البشر غير محتملة أو لا تستحق الكرامة، لا يمكنه أن يبني على أي قيمة إنسانية أو أخلاقية.
التضامن الاجتماعي يقوم على أسس أخلاقية. والأخلاق تعني الاعتراف بإنسانية الآخر، حتى لو كان مختلفًا. وكل خطوة في طريق نزع الإنسانية عن الآخر، هي خطوة في طريق تدمير ضميرنا الجماعي.
إذا ضحينا اليوم بالمهاجرين الأفغان، فغدًا سيكون الدور علينا.
هذه ليست نبوءة، بل درسٌ أعادت لنا التجارب الإنسانية تلقينه مرارًا.
فهل نجد اليوم من يصغي؟

كشف الهجوم الأخير من قبل إسرائيل على المراكز العسكرية التابعة للنظام الإيراني، مرة أخرى، عن الهوة العميقة بين الوطنية الحقيقية والدفاع عن النظام باسم الوطن.
ففي الوقت الذي يكافح فيه الشعب الإيراني الفقر، والقمع، وتدمير البيئة والانهيار العام، انضمّ البعض إلى صفوف المدافعين عن نظام حاكم يدمّر هذا الوطن نفسه، بذريعة "الدفاع عن الأرض".
لكن الدفاع عن "النظام القائم" لا يعني بالضرورة الدفاع عن الوطن. ولو كان الأمر كذلك، لوجب علينا اعتبار من دعموا طالبان في أفغانستان، أو خليفة داعش في سوريا والعراق، أو هتلر في ألمانيا، أو نظام فيشي في فرنسا، وطنيين.
الوطنية الأصيلة تتجلى في اللحظات التاريخية، لا في دعم الأنظمة الفاسدة والقمعية، بل في الوقوف إلى جانب الشعب والحرية والكرامة الإنسانية.
النظام الذي دفع ملايين الإيرانيين إلى الهجرة القسرية، ودمّر طبيعة إيران، واستنزف مواردها المائية، وأحرق الثروات الوطنية في مغامرات أيديولوجية، وأسكت صوت كل معترض بالرصاص والسجن، لا يستحق أي دعم، حتى في مواجهة هجوم خارجي.
يحاول البعض تشبيه الوضع الحالي بهجوم صدام حسين على إيران في عام 1980، ليستنتجو أن الدفاع عن النظام الإيراني هو دفاع عن الوطن. لكن هذه مقارنة باطلة من الأساس.
صدام جاء بهدف احتلال خوزستان وإنكار الهوية الإيرانية، مستهدفًا وحدة الأراضي الوطنية. جاء ليستولي على الأرض. أما في الحادثة الأخيرة، فإسرائيل لم تأتِ لاحتلال الأرض، ولم تستهدف الشعب الإيراني، بل ردّت على تهديدات مباشرة من قبل النظام الإيراني، وهي تهديدات تُكرر منذ سنوات على لسان مسؤولي النظام ضد وجود إسرائيل.
النظام الإيراني، من خلال دعمه للجماعات الوكيلة في أنحاء المنطقة، وتطويره لبرامجه الصاروخية والنووية، ومغامراته الأمنية، لم يعزل إيران فقط، بل أوصلها إلى شفا الانهيار الاقتصادي والسياسي.
هدف هذه الهجمات لم يكن إيران ولا شعبها، بل ذلك الجهاز الذي يحتجز إيران رهينة ويستغل اسم "المقاومة" لضمان بقائه. ومع كل هذا، لا يزال البعض يزعم أن كون النظام الإيراني في حالة صراع مع قوة أجنبية، يعني وجوب دعمه، وأن معارضته خيانة للوطن.
لكن التاريخ أثبت أن هذا الرأي ليس فقط ساذجًا فقط لكن خطيرًا أيضا. في فرنسا المحتلة من قبل ألمانيا النازية، أولئك الذين تعاونوا مع نظام فيشي التابع لمحتل، لم يُعتبروا لاحقًا وطنيين بل خونة للأمة والكرامة الوطنية.
في المقابل، أصبح الجنرال ديغول، الذي غادر فرنسا وقاد المقاومة من المنفى، بطلاً قوميًا، لا خائنًا.
التاريخ قد حسم الأمر بوضوح: الوطنية الحقيقية لا تعني دعم "النظام القائم" بشكل أعمى، بل تعني الدفاع عن حرية وكرامة الأمة، حتى لو تطلب ذلك التعاون مع قوة أجنبية للخلاص من محتل داخلي.
فالاحتلال لا يتم دائمًا بالدبابات والحدود، بل قد يكون على يد أيديولوجيا معادية للوطن، تتخذ شكلاً دينيًا أو ثوريًا، وتبتلع بنية الدولة وموارد الأمة وإرادة الشعب كما لو كان احتلالاً عسكريًا.
ما فعله النظام الإيراني بإيران طوال أربعة عقود لا يقل عن الاحتلال الأجنبي: قمع، ونهب للموارد، وتبعية إقليمية، وفي النهاية، قطع الصلة بين الشعب والدولة.
هناك أمثلة مماثلة في دول أخرى. ففي إيطاليا، من دعموا الفاشية في عهد موسوليني تم حذفهم من الذاكرة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية. وفي ألمانيا، واجه العديد ممن تعاونوا مع الحزب النازي النبذ الاجتماعي والسياسي. ولم يُذكر أيٌّ منهم في كتب التاريخ كوطني.
إذا كان النظام قد كبّل البلاد، وقلّص الاستقلال إلى مجرد شعار، وجرّد الناس من أبسط حقوقهم الإنسانية، فإن الوقوف إلى جانبه لا يعدّ دفاعًا عن الوطن، بل عن المحتل، سواء أكان هذا المحتل أجنبيًا أو يتحدث بلغة محلية ويرفع علماً محليًا.
الوطنية الحقيقية تعني الحفاظ على وحدة الأراضي، السيادة الوطنية، الكرامة والفخر للشعب الإيراني، وبناء مجتمع مزدهر يتيح لأبناء هذه الأرض أن يحققوا إمكانياتهم.
فالوطن لا يتمثل في الشعارات، بل في رفاه وحرية وكرامة الناس. ولا يمكن فصل الوطن عن أبنائه الشجعان؛ عن صوت بويا بختيارى، الذي صرخ قبل استشهاده الشجاع: "لدي أهل مثلكم.. أنا ابن هذا الوطن." عن الشباب الذين تُركوا في شوارع مظلمة، ولم يُسمح لهم بدخول المستشفيات، واستشهدوا مظلومين من أجل حرية الوطن.
كيف يمكن الادعاء بالوطنية والوقوف إلى جانب نظام أطلق الرصاص على قلوب هؤلاء الأبناء؟ كيف يمكن الادعاء بحب الوطن والتزام الصمت أمام دموع أمهات مجزرة نوفمبر؟ أولئك اللواتي سقط أولادهن في مستنقعات ماهشهر، أو كأم محسن شكاري، التي رفعت صوتها للسماء في قمة الضعف، لكن لم يردّ أحد.
الوطنية، كما ورد في قسم الولاء في العديد من الدول الحرة، تعني الوفاء للوطن في مواجهة الأعداء الداخليين والخارجيين. من يصمت أمام الجريمة والذل الداخلي، ويقف إلى جانب نظام دفع الأمة إلى الانهيار بالفساد والعنف، لا يمكنه الادعاء بالوفاء. لقد نقض القسم الأخلاقي والوطني الذي أدّاه.
النظام الذي دمّر الكرامة الوطنية عبر علاقاته التابعة مع الصين وروسيا، وحقّق أرقامًا قياسية في الفضيحة الاقتصادية بسبب ضعف عملته، وجعل أغلبية الشعب تحت خط الفقر، لا يمثل الوطن، ولا يستحق أي دعم.
من يقف اليوم إلى جانب النظام الإيراني، ليس مدافعًا عن الوطن، بل شريك في استمرار الجريمة والذل والخراب، حتى لو حاول تغليف هذه الشراكة بادعاء "مواجهة العدو الأجنبي".
هذا الشكل من القومية، كما وصفه أحد الأصدقاء، هو "قومية العبيد"، ويبعد كل البعد عن الوطنية الإيرانية المتجذرة في الحرية والكرامة والاعتزاز بالنفس.